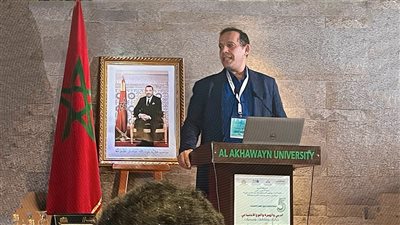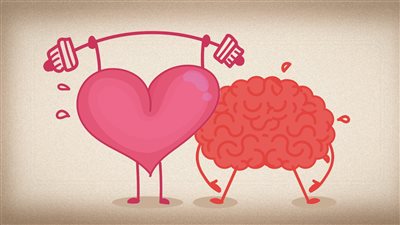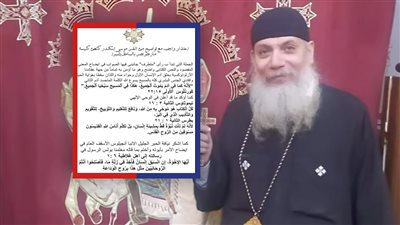في زمن تتعرض فيه البنى الأخلاقية الكونية لاهتزازات عنيفة على وقع الصراعات الجيوسياسية، وفي ظل استمرار حالة اللاعدالة التاريخية في فلسطين، تأتي الدراسات الفلسفية المعمقة لتكون بمثابة مساحة للمساءلة الراديكالية. ومن هذا المنطلق، يبرز كتاب الدكتور أحمد عبد الحليم عطية، "كانط وفلسطين: من كونجسبيرج إلى قدسنبرج"، كواحد من أهم المحاولات الفكرية الجريئة لـتفكيك العقل الاستعماري عبر استخدام أدواته المعرفية.
لا يقف عطية عند حدود التأريخ للفلسفة، بل يغامر بتحويل فيلسوف التنوير الأبرز، إيمانويل كانط، من أيقونة مجردة في مدينته الألمانية (كونجسبيرج)، إلى شاهد نقدي في قلب الصراع الفلسطيني (قدسنبرج). يطرح الكتاب سؤالاً وجودياً مزمناً: هل يمكن لأخلاق الواجب الكانطية، ومفهومها عن "السلام الدائم"، أن تصمد أمام حقيقة "العقل القاتل" و"سرقة الأرض والفيلسوف" في السياق الفلسطيني؟
هذا المقال النقدي يغوص في البنية الفلسفية للكتاب، محللاً محاولته للانتقال من نقد العقل النظري إلى "نقد العقل الصهيوني"، ومستكشفاً الثيمات المركزية حول الكونية والاستعمار، كما يسعى لتحديد الإضافة البحثية النوعية التي يقدمها عطية لحقل الدراسات الفلسفية والسياسية المعاصرة، كاشفاً في الوقت ذاته عن نقاط الضعف المنهجية التي قد تعترض محاولة "أدلجة" الفيلسوف في سبيل تحرير العقل والأرض. إنها قراءة تحليلية تضع الفكر الفلسفي في خندق المواجهة، مؤكدة أن العدالة لا يمكن أن تتحقق دون تطهير المفهوم كما تطالب بتحرير الجغرافيا.
تحليل البنية الفلسفية والفكرية للكتاب: إعادة تأويل كانط ضمن السياق الفلسطيني
يسعى كتاب الدكتور أحمد عبد الحليم عطية، "كانط و فلسطين"، إلى القيام بعملية تأويل راديكالي لواحد من أعمدة الفلسفة الغربية، إيمانويل كانط، عبر سحبه من سياقه الأوروبي النمطي (كونجسبيرج) وإقحامه في قلب الصراع الأيديولوجي والجغرافي الفلسطيني (قدسنبرج). يقدم عطية مسعى نقدياً يتجاوز مجرد المقارنة، ليجعل من الفلسفة الكانطية أداة تحليل أو هدفاً للنقد الموجه نحو بنية العقل الاستعماري الغربي تحديداً في نسخته الصهيونية.
البنية الفلسفية للكتاب تقوم على إعادة هيكلة للمفاهيم الكانطية الكبرى:
1. نقد العقل الاستيطاني: ينتقل المؤلف من "نقد العقل النظري" إلى "نقد العقل الصهيوني"، محاولاً كشف التناقضات الميتافيزيقية التي تبرر وتشرعن الاستيلاء على الأرض. هذا النقل المفهومي هو جوهر الأطروحة، إذ يحول الفلسفة الكانطية من بحث في شروط المعرفة إلى بحث في شروط العدالة والأخلاق الكونية المفقودة في حالة فلسطين.
2. أخلاق الواجب والمقاومة: يضع الكتاب مفهوم "السلام الدائم" الكانطي في مواجهة الواقع، مسائلاً إمكانية تحقيق هذا السلام في ظل وجود "العقل القاتل" و"السرقة" المزدوجة للأرض والفيلسوف. هذا التحويل يُلزم القارئ بالنظر إلى الأخلاق الكانطية (أخلاق الواجب) كأخلاق يجب أن ترفض الكذب (كحالة النازي واليهود) والسرقة، وبالتالي تدين المشروع الصهيوني.
تحديد الثيمات المركزية
تدور الثيمات المركزية في الكتاب حول محاور متداخلة:
• الكونية والاستعمار: التساؤل عن مدى كونية أخلاق كانط وهل يمكن أن تكون هذه الكونية محايدة أم أنها متورطة في التنوير الغربي الذي أنتج أو برر الاستعمار.
• الأخلاق والعدالة: تحويل نقاش الواجب الكانطي إلى واجب الدفاع عن الأرض والعدالة، ورفض التبرير الأخلاقي لأي فعل يؤدي إلى "الإبادة".
• نقد التنوير واليهودية: يخصص الكتاب فصولاً لدراسة "الحاخام كانط واليهودية المستنيرة" و"الكانطية واليهودية بين الوحي والتنوير"، مما يشير إلى محاولة نقدية لفحص العلاقة بين فلسفة التنوير ومسألة "التديّن في حدود العقل" الكانطية وبين المشروع الصهيوني الحديث، مع التركيز على علاقة كانط باليهود كـ (فويتسيك، فاكينهايم، مندلسون).
• الأنثروبولوجيا والهوية: يناقش الكتاب "الأنثروبولوجيا الغامضة" بين الفلسطينيين واليهود، ليتجاوز البعد التاريخي الجغرافي إلى البعد الأنثروبولوجي الذي يركز على الهوية في الفكر الغربي (الأنثروبولوجيا البرجماتية).
• نقاط الضعف في الكتاب (نقد البنية والمحتوى).
على الرغم من جرأة الأطروحة وأهميتها، يمكن تحديد نقاط ضعف منهجية ومعرفية، بناءً على البنية المعلنة:
1. خطر الاختزالية (Reductionism): إن سحب كانط مباشرة إلى سياق جغرافي وسياسي محدد (فلسطين) قد يعرّض الفلسفة الكانطية لخطر الاختزال. قد يقع الكتاب في فخ "أدلجة الفيلسوف" حيث يتم استخدام كانط كـ "شاهد" أو "أداة إدانة" بدلاً من تحليله كظاهرة فكرية معقدة. إن قفزة "من كونجسبيرج إلى قدسنبرج" تحتاج إلى جسور منهجية صلبة لتجنب الإسقاط.
2. القفزات المفهومية والمنهجية: العناوين الفرعية تظهر قفزات حادة، مثل الانتقال السريع من "نقد العقل الميتافيزيقي" الكانطي إلى "تناقضات العقل الصهيوني". هذا الربط يحتاج إلى تبرير معرفي دقيق يوضح كيف أصبح العقل الميتافيزيقي الكانطي (بإجراءاته المتعالية) متضمناً أو مؤسساً للعقل الصهيوني، بدلاً من كونهما مجرد نقيضين.
3. نقاط الضعف في النقد التاريخي للفلسفة: رغم الفصل المهم حول "المثالية الألمانية والمسألة اليهودية"، يفتقر التحليل النقدي إلى التعامل بعمق مع تطور الفكر الاستعماري ما بعد الكانطي (مثل هيغل وشلينغ ومساهمتهم في مفهوم الدولة والمصير)، مما يترك فجوة في ربط كانط بـ "العقل القاتل" بشكل خطي ومقنع.
4. نقد الذاتية الأخلاقية: كانط يركز على الذاتية الأخلاقية والواجب. إن نقد هذا الإطار في سياق سياسي خارجي (فلسطين) يتطلب نقداً تفصيلياً لحدود الكونية الكانطية ذاتها، ومدى فشلها في استيعاب مفهوم الغير المستعمر بدلاً من مجرد إدانة من خالفها.
استخلاص المضاف البحثي والموقع في حقل الدراسات المعاصرة
يقدم كتاب "كانط وفلسطين" إضافة بحثية نوعية ومهمة جداً، إذ يمثل نموذجاً لـ "فلسفة المقاومة المعرفية":
• توطين النقد الغربي: يُعد الكتاب محاولة رائدة لـ "توطين" نقد الفلسفة الغربية، عبر استخدام مفاهيمها الداخلية (كانط) لفضح تناقضاتها في سياق العالم الثالث/المستعمر (فلسطين). إنه يحوّل كانط من أيقونة للتنوير إلى مادة للتحقيق الجنائي الفلسفي.
• إعادة تعريف السلام الدائم: يُجبر الكتاب الفكر الفلسفي على إعادة تعريف مفهوم "السلام الدائم"، مشيراً إلى أن أي سلام لا يقوم على أساس أخلاقي (رفض السرقة والكذب) هو مجرد "وقف قتال" سياسي (مثل سلام كيسنجر)، وليس سلاماً دائماً حقيقياً مستمداً من العقل العملي.
• موقع الكتاب في حقل الدراسات المعاصرة:
• يقع الكتاب في تقاطع مهم بين دراسات ما بعد الكولونيالية الفلسفية (Postcolonial Philosophy) ونقد الحداثة الغربية.
• إنه يشكل جزءاً من تيار نقدي معاصر يسعى لتفكيك الأنساق الفلسفية الأوروبية المؤسسة للمشروع الإمبريالي/الاستيطاني (على غرار ما فعله إدوارد سعيد لكن من بوابة كانط)، وهو يمثل إضافة نوعية في مجال الدراسات الفلسفية العربية المتخصصة في نقد الأيديولوجيات الصهيونية من منظور فلسفي عميق.
• يهدي المؤلف عمله إلى جمال حمدان وعبد الوهاب المسيري، مما يؤكد سعيه لتأطير العمل في سياق فكري عربي يهدف إلى تحرير العقل والأرض من خلال النقد المعرفي.
في الختام، يمثل كتاب الدكتور أحمد عبد الحليم عطية، "كانط وفلسطين: من كونجسبيرج إلى قدسنبرج"، إسهاماً فكرياً جريئاً يتجاوز حدود الدراسات الفلسفية التقليدية ليضع الفلسفة في قلب المواجهة السياسية والأخلاقية الراهنة. إن الرهان الأساسي للكتاب هو تحويل فضاء نقد العقل الكانطي من مجرد بحث في شروط المعرفة إلى أداة لتحرير العقل من البنى الميتافيزيقية التي تشرعن الاستيطان والسرقة. وعلى الرغم من أهميته البالغة في توطين النقد الفلسفي واستخدامه لتحليل مفاهيم مثل "السلام الدائم" و"أخلاق الواجب" في سياق القضية الفلسطينية، تظل قوة الكتاب مصحوبة بتحديات منهجية. تكمن نقاط الضعف بشكل رئيسي في خطر الاختزالية الأيديولوجية لعمق الفلسفة الكانطية، والقفزات المفهومية الحادة التي تربط بشكل مباشر بين التناقضات الميتافيزيقية وتناقضات العقل الصهيوني دون جسور معرفية كافية.
ومع ذلك، يظل المضاف البحثي للكتاب حيوياً، إذ يضعه في مصاف الأعمال الرائدة في فلسفة المقاومة المعرفية. فمن خلال مساءلة الكونية الكانطية وتفكيك علاقة التنوير باليهودية، ينجح عطية في إثارة تساؤل جوهري حول إمكانية بناء عدالة حقيقية (قدسنبرج) ما لم يتم رفض الكذب والسرقة، وتحرير العقل والأرض. إن هذا العمل يعد دعوة مفتوحة للفكر الفلسفي العربي لمواصلة النقد الجذري للأنظمة المعرفية الغربية المتورطة في إدامة الاستعمار، مؤكداً أن تحرير الأرض يبدأ بتحرير العقل.